علاقة المرء مع غيره في نهج البلاغه
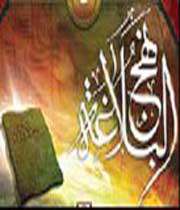
(1) إذا كان علي عليه السّلام قد وضع لنا هذه القاعدة النبيلة في قياس الفضيلة والخير وهي: ألاّ نعمل في السر ما نخجل من عمله في العلن حيث قال: «واحذر كل عمل يعمل به في السر ويستحي منه في العلانية» فإنه قد حبانا أيضاً بمقياس نبيل لأعمالنا تجاه الآخرين في قوله الخالد: «يا بني اجعل نفسك ميزاناً فيما بينـك وبين غيرك فاحبب لغيرك ما تحب لنفسـك واكره له ما تكره لها ولا تظلم كما لا تحب أن تُظلم» ولو اتبع البشر هاتين النصيحتين لامتنع الظلم والشر جميعاً، غير أنه يمكن أن نلاحظ ملاحظة متواضعة علي النصيحة الأولي: تلك أن نظرة المجتمع قد تتغير نحو بعض الفضائل أو الرذائل فإذا كان ما يستحي من عمله يعمل علي رۆوس الأشهاد فهل الفضائل خالدة؟ أم هي يجري عليها ناموس التطور؟ وهل يطيع نصيحة الإمام أم لا يطيعها رجل يحتسي الخمر علي قارعة الطريق غير خجل لكثرة من يحتسونها؟ أما أنا فأميل إلي القول بأن الفضائل خالدة، وأن الكذب لن يكون فضيلة لأن الناس يكذبون، بل الفضيلة فضيلة والرذيلة رذيلة ولن يزال راكبها يشعر في نفسه بالتضاۆل وبنوع من الحياء لا حين يلقي أمثاله ولكن حين يلقي الأخيار.
وما لي أذهب بعيداً؟ إن الإمام يفسر لنا ذلك في موضع آخر حيث يقول في بيان شاف: «إن المۆمن يستحل العام ما استحل عاماً أول ويحرم العام ما حرم عاماً أول وإن ما أحدث الناس لا يحل لكم شيئاً مما حرَّم الله عليكم، ولكن الحلال ما أحلَّ الله والحرام ما حرَّم الله».
(2) وإذا ذكرنا تطور الفضائل وخلودها فلنستعرض رأي الإمام القائل: «اقدموا علي الله مظلومين ولا تقدموا علي الله ظالمين».
(3) ولقد دعاء الإمام إلي التعاون دعوة صريحة في عبارة نبيلة حيث قال يودع جنوداً ذاهبين للقتال: «وأي امريء منكم أحسّ من نفسه رباطة جأش عند اللقاء ورأي من أحد إخوانه فشلاً، فليذب عن أخيه بفضل نجدته التي فضل بها عليه كما يذب عن نفسه فلو شاء الله لجعله مثله». وما أوصي به الإمام جنود جيشه يصح أن يستوصي به جنود الحياة. إن الغني لو ذبَّ عن الفقير بفضل ماله الذي فضل به عليه والعالم لو ذب عن الجاهل بفضل علمه والحكيم لو أرشد السفيه بفضل حكمته، لو كان هذا سبيل الناس في الحياة، لانتصر جيشهم علي آلام الحياة القابلة للانهزام. إن الإمام لا يزال يلح في دعوته إلي التعاون، وأنه ليسوقها هنا في منطق واضح وحجة لازمة: «أيها الناس إنه لا يستغني الرجل وإن كان ذا مال عن عشيرته ودفاعهم عنه بأيديهم وألسنتهم» «ألا لا يعدلن أحدكم عن القرابة يري بها الخصاصة أن يسدها بالذي لا يزيده إن أمسكه ولا ينقصه إن أهلكه، ومن يقبض يده عن عشيرته فإنما تقبض منه عنهم يد واحدة، وتقبض منهم عنه أيدٍ كثيرة».
إن الإنسان مدني بالطبع أو هو كما وصفه فيلسوف اليونان «حيوان اجتماعي» ولهذا دعا الإمام دعوته.
(4) وقد تكررت دعوة الإمام هذه في صورة أخري في حثه علي الصدقة بقوله البليغ: «وإذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل زادك إلي يوم القيامة فيوافيك به غداً حين يحتاج إليه فاغتنمه وحمّله إياه». وبوصيته: «إن اللسان الصالح ـ أي الذكري الطيبة ـ يجعله الله للمرء في الناس خير له من المال يورثه من لا يحمده». وفي تذكيره بفريضة الزكاة في قوله: «إن الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء فما جاع فقير إلاّ بما مُتَّع به غني والله تعالي سائلهم عن ذلك». وقد بلغ من تقريره للتعاون ولأثر الزكاة والإحسان في إسعاد إفراد المجتمع جميعاً أنه استنَّ تشريعاً طريفاً بقوله: إن الرجل إذا كان له الدين الظنون يجب عليه أن يزكيه لما مضي إذا قبضه» أي أن من كان له دين ولم يكن واثقاً أن مدينه سيرده إليه سالماً، ثم رده إليه بعد عامين مثلاً، وجب عليه أي علي صاحب المال الدائن أن يدفع للفقراء زكاة هذا المال للسنتين الماضيتين. ولست أعرف حكم الشريعة الإسلامية في هذا. ولكني ألاحظ أن رأي الإمام وجيه إذا اعتبرنا أن المال صار بالنسبة للدائن مفقوداً بوجوده عند من لا يثق به. فإذا عاد إليه فكأنما عثر علي كنز غير منتظر. وإذاً فليس كثيراً أن يدفع منه شيئاً للفقراء إن لم يكن زكاة عنه فشكراً لله عليه. «ومن كثرت نعم الله عليه كثرت حوائج الناس إليه» كما قال الإمام وكما قال شكسبير: «إن التشاريف العظيمة أحمال عظيمة».
(5) لقد زهد الإمام بهذه الدنيا وأهاب بها أن تغر غيره. بل لقد زمجر منها في صرخته: «والله لو كنت شخصاً مرئياً وقالباً حسّياً لأقمت عليك حدود الله في عباد غررتهم بالأماني وألقيتهم في المهاوي» هكذا كانت نظرته الصادقة إلي الحياة فلا عجب أن يمتلأ قلبه بالعطف علي الناس وأن يدعو إلي إنقاذ الضعفاء وعدم خزن المال بكلمته الرهيبة: «يا ابن آدم ما كسبت فوق قوتك فأنت فيه خازن لغيرك».
إن الشعور السائد علي نهج البلاغة كله هو شعور التنديد بالتهالك علي الدنيا: «وحفظ ما في يديك أحب إِلَّي من طلب ما في يد غيرك... فاخفض في الطلب وأجمل المكتسب فإنه رب طلب قد جرَّ إلي حرب.. فليس كل طالب بمرزوق ولا كل مجمل بمحروم». هذه وصاياه ولكنه لا يدعو إلي الزهد الذي ينافي الدين والحياة. فهو يعمل ويحارب. ولكن علي أرض الشرف ولغاية نبيلة.
(6) إن ما مرَّ بنا من دعوته إلي التعاون والإحسان ووفاء الزكاة ليس إلاّ بعض دعوته إلي «الحب العام» فإن قلبه النبيل قد غمر بهذه العاطفة الشريفة وثبتها إيمانه القوي المنقطع النظير وليس غريباً ممن صادق النبي ـ والأصدقاء قليل ـ وشاطره آلامه وجهاده، فشعر بحلاوة الصداقة. ومن عاني من الحسد والحقد اللذين دفعا معاوية وغيره لمناوأته. ومن خبر تأثير التخاذل والتباغض حين خرج الخوارج وتخاذل قومه، ليس غريباً علي من هذا شأنه أن يهيب بنا: «ولا تحاسدوا فإن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب ولا تباغضوا فإنها الحالقة». وأن يقول: «صحة الجسد من قلة الحسد» ذلك القول الذي تۆيده ملاحظتنا اصفرار الوجه ونحوله فيمن عرفوا بالحقد. وأن يقسم لنا: «والذي وسع سمعه الأصوات ما من أحد أودع قلباً سروراً إلاّ وخلق الله من ذلك السرور لطفاً فإذا نزل به نائبة جري إليها كالماء في انحداره حتي يطردها عنه كما تطرد غريبة الإبل» وأن يوصينا خيراً بجيرتنا قائلاً: «الله الله في جيرانكم فإنها وصية نبيكم، ما زال يوصي بهم حتي ظننا أنه سيورثهم».
(7) قلت أنه قد عرف الصداقة في نفسه وخبرها فلنستمع إلي وصاياه بصددها. لقد بالغ في طلب الحرص علي الصديق الوفي حتي قال: «ولا يكن علي مقاطعتك أقدر منك علي صلته» وأوصي بالبحث عن الرفيق قبل الطريق. وحمد الذين«يتواصلون بالولاية ويتلاقون بالمحبة» ودعا إلي عدم الكلفة بين الأصدقاء بقوله: «شر الأخوان من تكلف له» ولكنه نصح أيضاً بعدم الاندفاع في حب الصديق أو بغض العدو بقوله: «أحبب حبيبك هوناً ما، عسي أن يكون بغيضك يوماً ما، وابغض بغيضك هوناً ما، عسي أن يكون حبيبك يوماً ما» ولقد نتساءل كيف يشك الإنسان في صديق وفي خيره فيحتاط في صداقته وكيف تستقيم صداقة مع تحوط. ولكنا لا يصعب علينا أن نعرف ما حمل الإمام علي قول ذلك فقد عاني من تقلب الأصحاب وانشقاق الأخوان ما عاني. ولعلَّ هذا العناء هو ما دفعه ـ ولنقل ذلك ونحن بمعرض آرائه في الصداقة ـ إلي أن يقول: «الوفاء لأهل الغدر غدر عند الله والغدر بأهل الغدر وفاء عند الله» إن هذه الكلمة القوية ما كانت لتصدر من ذلك القلب الوادع المسالم لولا أن أصابته شظايا الغدر فثار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق